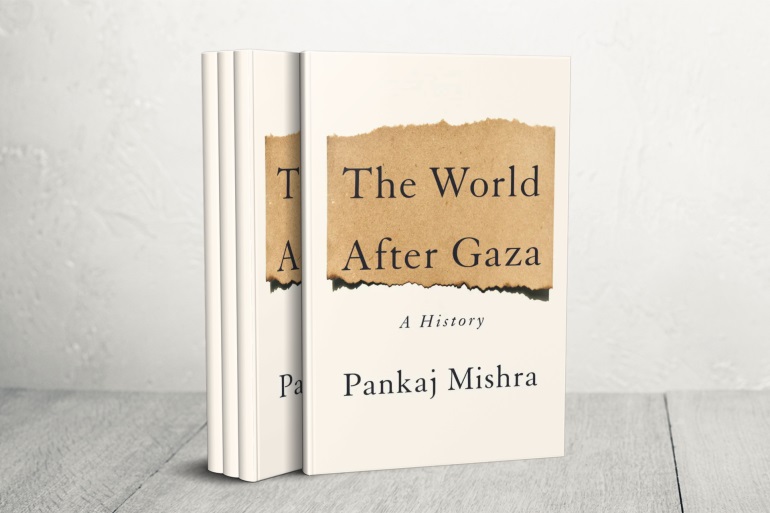محمد ولد محمد سالم
تكمن براعة الروائي أمير تاج السر في روايته “زهور تأكلها النار” التي دخلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018، في قدرته الفذة على رسم تفاصيل المكان، وتأثيثه بكل ما يلزم من مظاهر الحياة في مدينة مصرية نائية في نهاية القرن التاسع عشر، فقد اخترع مدينة مصرية سماها “مدينة السور”، تقع في غرب البلاد، وأخذ يشكل معالمها من خلال عين راصدة خبيرة بتفاصيلها، هي عين بطلته “خميلة” الفتاة المتعلمة الراقية ابنة جماري عازر أو “جماري الزعيم” أكبر تاجر للذرة في المدينة، التي درست علم الجمال لمدة عام في القاهرة، وعادت لتزهو به في مدينة قروية لا تعرفه، وصارت قادرة على رصد أدق التفاصيل في ما تبصره عيناها من معالم الحياة، واكتشاف الانسجام فيه أو التنافر، خاصة في مدينتها مدينة السور التي “لم تكن كبيرة ولا معقدة، ولا تضيع فيها القرابة والصداقة، وحتى مجرد المعرفة السطحية، إلا نادرا”.
يتداعى وصف المدينة متحدّرا مع ذكريات “خميلة” عن حياتها السابقة بعد سنوات من المأساة التي أصابتها، فتصف وضيعتها كابنة وحيدة لتاجر كبير ذي نفوذ واسع يوفر لها كل أسباب الراحة، وأم إيطالية رسامة وقعت في حب ذلك التاجر، وقبلت أن تتزوجه وتستقر معه في مدينته النائية في هدوء وصمت، وفي بيتهم الواسع تحظى الفتاة بكل وسائل الراحة والعطف والحنان، ونعرف من خلال ذلك الوصف أن المدينة صغيرة نسبيا، ويحكمها والٍ تركي متجهم، ويعيش فيها في سلام أخلاط من الناس منهم المسلمون والمسيحيون الأقباط، وأسر يهودية وبعض المهاجرين الهنود البوذيين، والأفارقة الزنوج، وعلاقاتهم جميعا ممتازة منسجمة، ويعيش الأقباط الذين تنتمي إليهم البطلة في حبور ودعة توفرها لهم ثرواتهم وتجارتهم التي يمتهنونها ووظائفهم الحكومية، ما جعلهم جميعا أعضاء في نادي “يتوبيا” الذي لا يدخله إلا المترفون من أبناء المدينة، وتستعرض طبيعة وحياة عدد من الشخصيات الذين ارتبطت حياتها بهم من قريب أو بعيد، وعلى رأسهم مخائيل رجائي الذي ارتبطت بخطوبة، وباسيلي أكرم، وزواجه الغريب من الهندية البوذية أمبيكا بسواس، وإيزاك موسى اليهودي صائغ الذهب، وطرطور القبطي، ووالي المدينة المتعجرف صديق والدها، وغيرهم، وبعض النساء اللواتي ترتبط بهن، ويسترسل السرد مطولا ليحيط بكل ملامح المدينة قبل أن يصل إلى اللحظة الحاسمة التي تغير فيها كل شيء عندما اجتياحها أتباع “المتقي” المتطرفون، فدمروا المدينة، وقتلوا رجالها، وسبوا نساءها، ونهبوا خزائنها، وأخذت خميلة سبية بين السبايا، ووضعت في منزل محروس مع عدد من سبايا المدينة تديره نساء متجهمات يعملن لصالح “المتقي” وأتباعه وتتلخص مهمتهن في تغيير معتقدات النساء، وجعلهن يحملن معتقدات “المتقي” المتطرفة، وتغيير وهيئتهن ليكنّ على شاكلة نساء المتقي وأتباعهن، وهي مرحلة التطهير التي لا بد منها لتصبح الواحدة منهن جاهزة لإرسالها إلى أحد أمراء الحرب الكثر الذين يملأون أرجاء المدينة، ويعثيون في الأرض فسادا باسم “المتقي” ومعتقداته الإجرامية، وتطول فترة تطهير خميلة التي اكتسبت هناك اسما جديدا هو “نعناعة”، وتكون شاهدة على مأساة كثير من رفيقاتها اللاتي عذبن أو قتلن أو دفعن إلى أحد الأمراء، وبينما كانت خميلة تهيأ لتقدم إلى “المتقي” نفسه، يحتال أحد الحراس الخصيان الذين يتولون حراسة النساء، لها فينتشلها، ولا توضح الرواية هوية ذلك الخصي الذي انتشلها، لكنها تترك مؤشرات عل أنه يمكن أن يكون أباها الذي اختفى في أول الاجتياح، وكان يعتقد أنه مات مدافعا عن مخازنه، فقد يكون تقمص شخصية خصي، ودبر لإخراجها من الحجز، وتنتهي الرواية وقد خرج بها من المدينة.
يصنع أمير تاج السر من معالم المكان وحركة الناس فيه، وتداعيات علاقاتهم مشهدية سلسلة مسترسلة، تختطف خيال القارئ وهو يتابع الصفحات، لتغويه بالدخول إلى تلك المشهدية، ومواصلة السير فيها، حتى النهاية، متجولا في طرقات “السور” وشوارعها وأسواقها، وداخلا في بيوتها وخدور نسائها، مستشعرا جو الهدوء الذي تعيشه، والذي لا يخرمه إلا حفلات نادي “يوتوبيا” الباهرة أو ضحوات السوق الذي يعج بالباعة والمشترين والتجار القادمين من القاهرة ومختلف المدن الأخرى، ما يشعرنا بالجهد الكبير الذي بذله الكاتب في جمع المعلومات حول معالم المدن القديمة، وشكل الحياة التي كان يحياها الناس في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في تلك المدن، ووظائفهم وعلاقاتهم، ويضفر من ذلك مشاهد متتابعة كأنها شريط سينمائي يدور أمام عيني القارئ، ما يعطي للعواطف والميول النفسية والعلاقات الاجتماعية مرتكزا ومرجعا تتأسس عليه وتؤول إليه، فحين يصور الكيفية التي بها اشتبك رجائي في علاقة مع خميلة بشكل حاسم يجعل السوق مسرحا لذلك في أحد الأيام التي خرجت فيها “خميلة” إلى السوق في بستان راق يخلب الأنظار، ومرت أمام ميخائيل رجائي الذي كان في السوق يشرف على عمال يبنون مظلة كبيرة كان يريد أن ينظم تحتها بائعات الطحين، اللواتي كان يجني منهن ضرائب للولاية، فلحقتها عينه إلى بائع محل بائع الذهب اليهودي، يقول تاج السر على لسان بطلته: “شاهدني، كما يبدو، وكنت أرتدي فستانا أسود مطرزا بالأحمر والأزرق والذهبي، أنا من اخترع تفاصيله وخاطه وطرزه بإرشاد من علم الجمال، وكثير من الصبر، وكذا قال ميخائيل، حقيقة، لم يقل بلسانه، فلم يكن ثمة حوار بيننا، أو معرفة موثقة تجعله يطرب للجمال ويتحدث عن طربه، لكنّ عيناه هما اللتان تحدثتا بوضوح، وأنفه احمرّ وابيضّ واحمرّ.. توقف فجأة عن ضخ التعليمات، وتسمر مهلهل الثياب يتابع مشيتي، وكنت ذاهبة فقط، ذاهبة في أي اتجاه تقودني فيه خطواتي، فلم يكن ثمة هدف كبير ولا صغير في السور لأحدده، وأذهب إليه.. توقفت عند صائغ الملكات، ذلك المحل الذي يملكه ازاك موسى، وكان يهوديا مؤسسا عند ولادته لصياغة الذهب وبيعه دون أدنى تعاطف مع الدنيا وتقلباتها، كانت عنده امرأة شابة وبدينة بعض الشيء، تود بإصرار شراء أساور من نقشة (الغزال) وهي من النقشات الرائجة تلك الأيام، لكنها غالية الثمن، كانت تحاوره بمجون وهي تتكئ على طاولة البيع، تحاول زحزحته عن الثمن الذي حدده بلا فائدة، وفي النهاية اضطرت لإخراج نقودها علبة جلدية كانت تحملها، واستلمت أساورها”، وتسترسل البطلة الراوية في وصف وضعية سوق الحلي، وبراعة ذلك التاجر اليهودي الصلف البخيل، قبل أن تعود إلى ميخائيل رجائي الذي ظل يراقبها وهي داخل المحل حتى التفت ورأته، فاضطر إلى سحب نظراته بسرعة، وكانت رؤيته لها على تلك الهيئة دافعا مباشرا له إلى طلب يدها.
طيلة الرواية يشغل الكاتب حواسّ القارئ بما يملأها، من مناظر وألوان ورائحة وطعم وملمس، لا يترك شيئا من ذلك إلا وظفه ببراعة، وفنية مدروسة، تبهر قارئه، وبلغة سلسة جميلة، وقد كان اختيار فتاة درست علم الجمال خارج مدينة السور المتخلفة التي يعيش نساؤها كل ألوان الفوضى والعشوائية، اختيارا فنيا ذكيا، جعل الأفكار تتدفق على لسانها بمنطقية لا يمكن الاحتجاج عليها، فهي شخصية مؤهلة نظريا لقول ما تقوله، وتفسير ما تشاهده، وما يمر عليها من أحداث، ولم تتغير هذه الوتيرة حتى في المرحلة الثانية من الرواية عندما سقطت المدينة تحت ضربات المتطرفين الإرهابية، فقد ظلت البطلة ترصد ما يحدث في محيطها الذي أصبح ضيقا، ومحدودا، لكنّ ما حدث في هذه المرحلة هو انصراف السرد إلى خارج عالم البطلة الخاصة، فقد انصرف سرد البطلة إلى رسم حالة رفيقاتها ومآسيهن ومآلاتهن دون رسم حالتها هي إلا فيما ندر، وبدا أن حكايتها توقفت نهائيا لصالح حالات رفقياتها “الزهرات” اللواتي تأكلهن نار المتطرفين، واحدة تلو الأخرى، وهو ما وفر للرواية تواصلا من نوع ما، لكنه أوقف فجأة حكاية البطلة، حتى النهاية التي قيض الله لها فيها ذلك الشخص المتخفي في زي “حارس خصي” فأنقذها، وقد جعل ذلك السرد يبدو محايدا بالنسبة للبطلة وبالنسبة للقارئ نفسه الذي فقد خيط الاسترسال في طرقات متعرجة هي حيوات ثانوية لرفيقاتها، اللواتي شهدن معها أيام العذاب الأليم، وربما أحس الكاتب بذلك التشتت الذي تسرب إلى الرواية فعمد إلى الإسراع بالوصول بها إلى نقطة النهاية حتى لا يفقد القارئ خيط التواصل المستمر معها.
وأيا كانت الملاحظات التي يمكن إبداؤها على رواية “زهور تأكلها النار” فإنها لا تنقص شيئا من حقيقة كونها رواية بديعة بقلم كاتب متمكن، ولن يكون فوزها بالجائزة العالمية للرواية العربية، إن فازت بها، إلا فوزا مستحقا.
__
[email protected] *
tweet