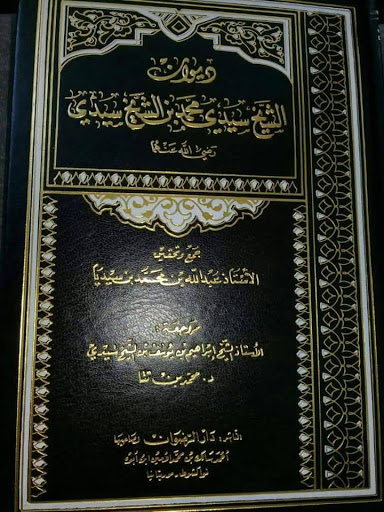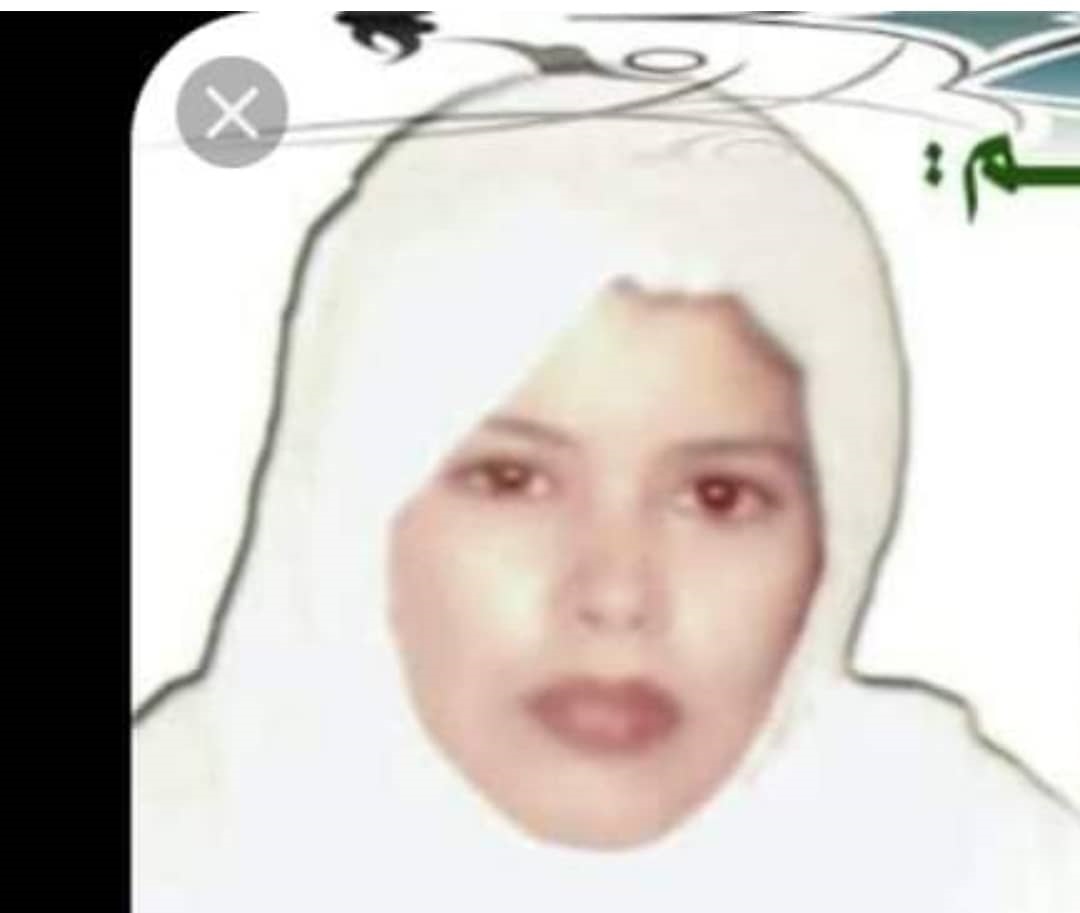كانت تلك الدروس التي يقدمها
الشاب الحلي لحطط تُسمى
الدروس المنزلية، أو السكنية
؛ باعتبار المنزل خيمة،
حفاظا على التراث، و الموروث
ففي الخيمة ما لا يملكه غيرها.
فالخيمة بسيطة التكاليف، و سهلة
الإصلاح دائما.
الخيمة جزء متفاعل مع البئة فهي
منها و ستعود إليها، دون أن يكون
هناك شيء ضار بمستقبل الحياة.
الخيمة من حيث الشكل تحافظ على انسيابية المنظر ، فكأنها وردة بيضاء
بين الأشجار و الرمال، و إذا كانت
سوداء فكأنها من بقايا الصخور
القديمة، و التي تُشكل معالم الأرض.
و الخيمة تتفاعل مع الرياح و المطر،
فهي منسابة مع الصدمات، و كأنها
تُسلم الحركةَ و الشحنةَ إلى طرف
آخر ، يُسلمها بدوره.
الخيمة من حيث تبديل الهواء ربما
تكون السكن الأكثر صحة في العالم؛
ذلك أن الهواء يتبدل بشكل دائم
لتُداعب النسمات أجفان الجالسين.
و الخيمة لا تحجب كل الحرارة، و لا
كل البرودة، فالأجسام بحاجة إليهما
دائما، و مواد اليوم بعضها يعزل
كل شيء، و كأنه سجن للرياح و للنسيم، و للضوء و الحرارة.
و من يدري فقد يكون ترك الخيمة
سببا في كثير من الأمراض و العاهات
و انحراف السلوك، و تبدل المزاج.
الخيمة بأبوابها الأربعة، تفتح مساحة
واسعة للدخول و الخروج، و كأنها حل
لمشاكل الطوابير، و دخول العمارات
و الفنادق اليوم، و هذا الاتساع قد
يبعث في النفوس عامل الراحة،
و يسمح باتساع الرؤية و الاستفادة
من المناظر، دون انكسار البصر
على حيطان صلبة، تجعله يرجع
مسلوب الإرادة.
عدم سد الخيمة بالمتاريس و الحديد
و الأبواب الضخمة يجعل الداخل
يشعر بالراحة و الاطمئنان، و هذا
له فوائد على الحياة و السلوك،
فلا الأبواب الكبيرة منعت من السرقة
و الجرائم ، بل ربما كانت إشارة
أن وراءها مطلبا و غاية، و بذلك
سوغت للعصابات الدخول و الولوج.
ربما تكون الخيمة أسهل سكن،
من حيث الحمل و التبديل، و من
حيث البناء، و قد تكون أول سكن
بشري لا زال يحتفظ بوجوده رغم
هجوم المادة الصارم على كل أصيل
في عالم السرعة المخيف هذا.
الزعيم هرصبوب قاد على تشييد
المباني العملاقة، لكنه رأى بعينيه
مصير الذين شيدوها، إنهم في
شبرين من التراب الرملي، ينامون
هناك، و تلك البنايات لم تسأل عنهم يوما، و لا حتى تذكَّرهم سكانها الجدد.
لقد أخذ هرصبوب تراث الخيمة
عن والده و ذلك عن الجد ، فلماذا
يكون تراث السكن أقل أنواع التراث
اهتماما، و أكثره هدما.
الذي جعل هرصبوب يهتم دون غيره
بهذا النوع من التراث، أنه لا يملك
ذلك التراث الآخر ، الذي يحتل مرحليا
مصاف التراث البشري، و هو التراث المكتوب، و تراث النفائس المصنوعة
من الجواهر.
و لكن ما المانع من الجمع بينهما؟
أليس للسكن قيمة معنوية، لا تفقهها
عملات اليوم الورقية الخفيفة؟
إن هرصبوب يرى أنه يسد مكانا لا
يوجد غيره لسده، فهو الوحيد
اليوم في هذه البلاد، القادر على إبراز
قطع من ثياب القرن الثامن الهجري،
و قادر على النوم في أقدم خيمة
موريتانية معروفة على وجه تراب
الوطن الفسيح.
إنها خيمة لم تُطرح من سبعة قرون
متواصلة، فهل يستطيع عالم اليوم
أن يحاضر أمامه عن الأصالة؟أو عن
حب الوطن، أو عن الاستقرار؟
إنها مشاهد حية، فيها رائحة الزمن
المعتقة، و فيها طعمه السائغ، و فيها
صورته الخالدة، و فيها حركته الدائرة،
و قد يكون اهتراز الخيمة هو نبضات
الماضي القريب و البعيد، و قد تُكتشف كلمات و أحاديث خزنتهم
خيوطها لبعض السكان و الضيوف،
و حين تُكتشف سنعرف التاريخ
الحقيقي ، و نضع المزيف في
أكياسه السامة.
كيف سيكون العالم حين يستمع الشاب إلى تلاوة جده الخامس،
يحتفظ بها خيط من خيوط ما
فوق الحُمَّار؟
وكيف سيكون العالم حين نستعيد
تلك المجالس النادرة؟
و كيف سيكون الواقع حين نقدر
على تفريغ خزينة محفوظة من
تلك المشاهد و المواقف؟
إنه تطور إيجابي، مختلِف عن وسائل
الإلهاء و الإغراء، و سرقة الجيوب.