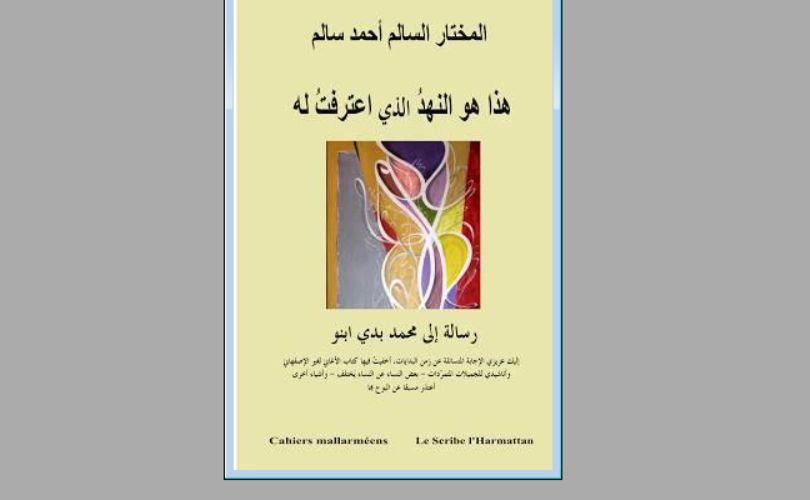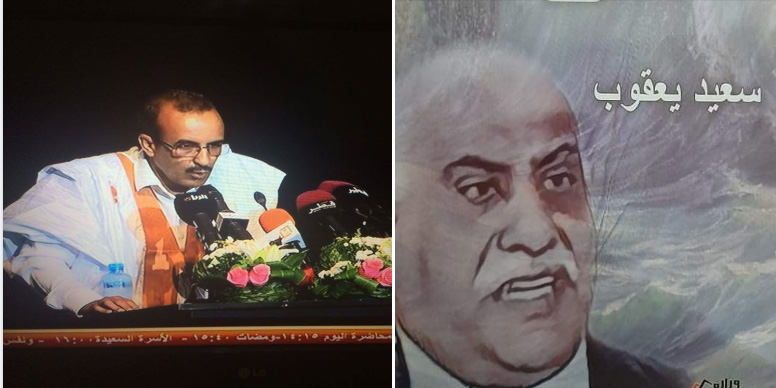لم تكن العصاري (الدحميس) في طفولتنا وصبانا كهذه العصاري التي نراها اليوم…
لا أعني غروب الشمس وحده، ولا احمرار السماء على كثبان الرمال، ولا نسيم المساء البارد وهو يمرّ على وجوهنا المتعبة من قيظ القائلة.
إنما أعني ذلك الإحساس الدافئ بسكون المساء، حين يهدأ كل شيء، وتنفرج الروح، ويستكين الجسد.
ذلك الإحساس بأنك تقف على أعتاب ليلة قادمة، لا لتقاوم، بل لتستريح: لتصغي، لتسامر، لتحتسي الشاي (الذهبي) بهدوء، لتعيش العمر بلا صخب ولا تكلّف ولا نفاق.
لماذا كانت الأصائل أبهى؟
لِمَ كانت العصاري أطول وأكثر بهجة، تتسع للحديث واللعب والأنس والمنجزات الصغيرة التي تملأ القلب بالرضا؟
أتذكّر جيدًا استراقي السمع من مجلس الكبار عصرا وأول مرة أستحق كاس شاي مع الجماعة..
كنت أعدّه نصرا واعترافا بالنضج، نجتمع حوله ونحن نسمع أحاديث الكبار، وننصت للحكايات عن المواشي وضالتها وحديث الحاسي طبعا.. ثم قبيل الغروب نتمشى خارج الحي ونراقب كيف تسدل السماء ستائرها الزرقاء شيئًا فشيئًا.
كانت القرية كلها كأنها تودع الشمس ساعة مغيبها.
كانت قريتنا — على أطراف الصحراء — قرية عصاري نظرا لاشتداد الحر في الهواجر.
كانت البركة أعمق، والأنفس أصفى، والحياة أيسر.
لكن، حين صار الناس عبيد هواتفهم، اختلت المواعيد، وضاعت البركة.
اليوم، جاءت فجوة عميقة بين هذا كله وبين تعليم متراجع، وأجهزة ذكية بأيدٍ غير مؤهلة، فاختلت الموازين، وصار كثيرون يستعملون التقنية للفضح والانفصال بدل الوصل والبناء.
إن الأصيل سر صناعة الليل، وصناعة الليل هي سر صناعة العمر، وصناعة العمر هي المجد النافع الباقي.
الأصيل نعمة من نعم الله، كلما رأيناه تذكّرنا نور الله ومحبته وهي تفيض على القلوب.
وقديما تغنت العرب بالأصيل والأصيلال..
وقال أبو الطيب:
كأن أوقاتها في الطيب آصال.. فجعلها مضرب المثل في طيبها..
وقد عنونت أحد دواويني الشعرية بعنوان "أنخاب الأصائل"..
اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واكفنا شرّ من لا يعرفون للغروب هيبة ولا للسكينة معنى.