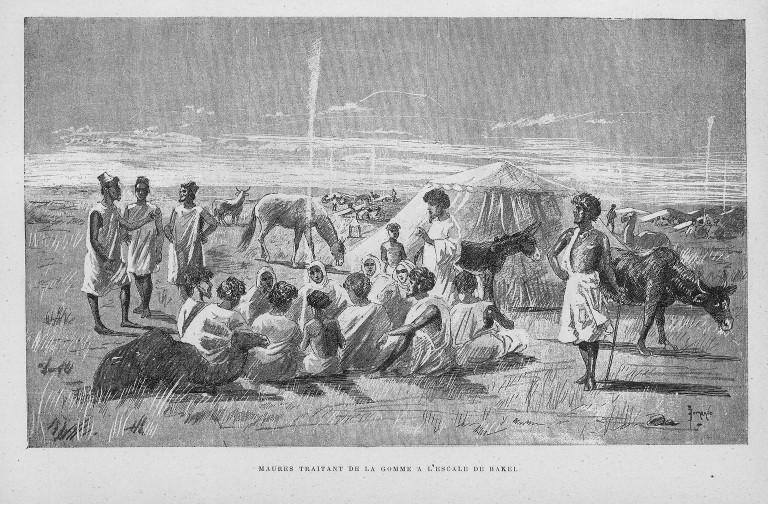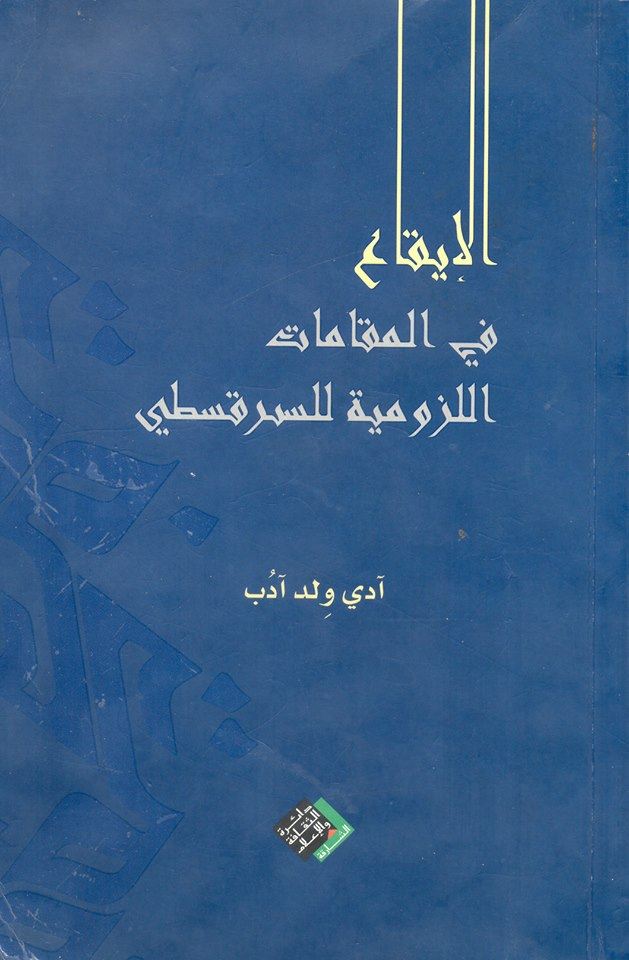ألفة الشاعر العربي الطويلة مع الصحراء، وعيشه فيها وارتباطه بها، لم تمنعه من التوق دوما إلى بيئة أكثر رخاء وطمأنينة، ومن هنا نفهم تلك الاحتفالية التي كان يقيمها للمطر، كلما رأى السحب تتشكل، أو شاهد المطر ينزل.
لقد تفنن الجاهليون في تتبع مساقط الغيث، وتنبأوا بها، وشاموا البرق، ووصفوا المطر، وتمنوا أن يحل بمرابع الحبيبة حتى لا تترحل عن ديارها، وطلبوا به السقيا لموتاهم، فظل في خيال الشاعر رمز الحياة والخصب والنماء، ومؤشر الاستقرار والهناء.
وليس هذا الاحتفاء بالمطر إلا ترجمة للميل الفطري لدى الإنسان إلى الحياة الناعمة، وما تبعثه في النفس من إحساس بالدعة والجمال.
لذلك ما إن انتقل العربي من شبه الجزيرة إلى بيئات أخرى كالشام، والعراق، وبلاد ما وراء النهرين، والأندلس، حتى ظهرت في شعره مسحة الطبيعة الحانية، واستبدل معجم الصحراء الجاف بمعجم جديد يتسم بالرقة والليونة، ظهر ذلك مع شعراء في العهد الأموي ولكن المسحة الجاهلية ظلت أقوى وأكثر حضورا في الشعر.
ولقد سجل الشعراء العباسيون السبق في الحديث عن جمال الطبيعة واحتفوا بفصل الربيع ومظاهره البهيجة؛ ولعل هذا الاهتمام راجع إلى سببين اثنين؛ الأول هو أنهم أصبحوا يعيشون في بيئة تختلف عن بيئتهم في شبه الجزيرة، والثاني هو تأثير الحضارة الفارسية في الثقافة العربية، فقد كان ملوك الأكاسرة يحتفلون بعيد النيروز، ويتبادلون فيه الهدايا ، لأنه يصادف بداية فصل الربيع، وانتقلت هذه العادة إلى العرب وقتها بسبب المعايشة ، لذلك احتل هذا الفصل حيزا معلوما في كتاباتهم نثرا وشعرا، وبالغوا في وصفه، يقول الكاتب علي بن عبيدة متحدثا عن فصل الربيع وكأنه يتحدث عن إنسان من لحم ودم: "الربيع جميل الوجه، ضاحك السن، رشيق القد، حلو الشمائل، عطر الرائحة، كريم الأخلاق".
وتمتد هذه الصورة الناصعة للربيع وتتسع في قصائد الشعراء ، فنجد البحتري يصف مقدم الربيع وصفا بليغا، يقدم لنا فيه لوحة فوتوغرافية تنطق صورها بالحركة، وتشي بالحيوية، وتنقل للمتلقي المشهد بكل عنفوانه وإشراقه ، معتمدا في ذلك على تشخيص عناصر الطبيعة، ومشبها أريج الأزهار بأنفاس الأحبة حين يقول:
أَتَاكَ الرَّبِـــيـعُ الطَّلْـقُ يَخْتَـالُ ضَـاحِكًـا ** مِنَ الْحُسْنِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَـــا
وَقَدْ نَبَّـــــهَ النَّيْرُوزُ فِي غَسَـقِ الدُّجَى ** أَوَائِــلَ وَرْدٍ كُـــنَّ بِالْأَمْــسِ نُــوَّمَــا
يُفَـتِّـقُـهَا بَـــرْدُ الـــنَّـــدَى فَــكَــــــأَنَّمَـــــــا ** يَــبُـــثُّ حَدِيثًا كَــــانَ قَبْلُ مُكَتَّمَــا
وَمِـنْ شَــجَـــرٍ رَدَّ الـرَّبِـيـــعُ لِــبَــــاسَــــهُ ** عَلَيْهِ كَمَا نَشَّـرْتَ وَشْـيًـا مُنَمْنَمَـا
أَحَــلَّ فَـأَبْـــدَى لِلْعُــيُـــونِ سَـمَــــاحَــــةً ** وَكَانَ قَذًى لِلْعَيْنِ إذْ كانَ مُحْرِمَا
وَرَقَّتْ حَوَاشِي الرَّوْضِ حَتَّى حَسِبْـتُـهُ ** يَجِـيءُ بِأَنْفَـــاسِ الْأَحِـبَّــــةِ نُـعَّـمَا...
أما ابن الرومي فيتفنن في وصف روضة من رياض بغداد الغناء، ويسخر عناصر الطبيعة من رياح و أشجار وطيور ليرسم لوحة بديعة تموج بالحيوية والجمال؛ تقيم فيها الطبيعة احتفاليتها، وهذه القصيدة استوحى منها شعراء موريتانيون كثيرا، وضمنوها قصائدهم: يقول :
حَيَّتْـــــكَ عَـــنَّا شَمَالٌ طافَ طائفُهَــا ** في جنَّـةٍ قـدْ حَــوَتْ رَوْحًـا وريْـحَـانَـا
هَبَّتْ سُحَيْرًا فَنَاجَى الْغُصْنُ صَاحِبَهُ ** سِــرًّا بِهَـا وَتَــدَاعَى الطَّـيْــرُ إعْــلانَــا
وُرْقٌ تُغَنِّي عَلَى خُضْــرٍ مُهَـــدَّلَـــــــةٍ ** تَسْمُـــــو بِهَـا وَتَشُــمُّ الْأَرْضَ أَحْيَـانَـا
تَخَــــالُ طَائِـرَهَا نَشْـوَانَ مِـنْ طَــرَبٍ ** وَالغُصْنَ مِنْ هَــزِّهِ عِطْفَـيْهِ نَشْوَانَا
لقد جعلت البيئة الجديدة الشعراء يتفننون في الاستمداد من الطبيعة، ويبرعون في تشخيصها ، حتى إن المتنبي الذي قصر شعره على أغراض الفروسية و المدح و الفخر، وتغنى بالصحراء، ورأى فيها عنوانا للأصالة والانتماء؛ نجده يُفتن بالمناظر الخلابة وذلك عندما مر على شعب بوان قاصدا عضد الدولة البويهي، فسحرته المغاني، وقدم لها صورا برع فيها مستثمرا القصص القرآني، والقصص القديمة، وجَلَّى في الوصف:
مَغَانِي الشِّعْـبِ طِيبًا فِي الْمَغَانِي ** بِمَنْــزِلَــةِ الرَّبِـــيـــــعِ مِــنَ الـزَّمَــــانِ
وَلَكِــنَّ الْفَــتَـى الْــعَــرَبِـــيَّ فِــيــهَـــــا ** غَـرِيـبُ الْـوَجْهِ وَالْيَــدِ وَاللِّــسَـــانِ
طَـبَـــتْ فُـرْسَـانَـنَــا وَالْخَـيْـــلَ حَــتَّـى ** خَشِيـتُ وَإِنْ كَرُمْـنَ مِــنَ الْحِـــرَانِ
لَــهَــا ثَـمَــرٌ تُــشِـــيـــــــرُ إلَيْـــكَ مِـنْــهُ ** بِـأَشْـــــــرِبَــــةٍ وَقَـــفْــــنَ بِــــلَا أَوَانِ
وَأَمْــــوَاهٌ تَـصِـــلُّ بِــهَــا حَـصَـــاهَـــــا ** صَلِيلَ الْحَلْيِ فِي أَيْـدِي الْغَوَانِي
مَـــلَاعِـــبُ جِـــنَّــــــةٍ لَوْ سَـــارَ فِـيـهَــا ** سُـلَيْمـانٌ لَسَــــــارَ بِـــتَـــــرْجُــمَـــــانِِ
يَـقُـــولُ بِــشِـعْـب بُـــــوانٍ حِصَــاني ** أَعَـنْ هَـذا يُـسَـــارُ إلَى الطِّــعَــانِ؟
أبُــوكُـــــمْ آدَمٌ سَـــنَّ الْــمَـــعَـــاصِـي ** وَعَـلَّـمَـكُـــمْ مُــفَــارَقَــةَ الْجِـــنَـــانِ
لقد عمد الشاعر إلى تصوير هذا الشعب تصويرا مثيرا، يمتزج فيه الجمال بالإدهاش والغرابة، فهو ربيع الزمان، و ملاعب الجن، بكل ما تحمله العبارتان: (ربيع الزمان-ملاعب الجن) من دلالة على البهاء الأسطوري للمكان؛ فالشاعر هنا يعبر عن روعة المنظر وينسبه إلى الجن ، مبالغة في التأكيد على أنه خارق للعادة ويفوق التصور، ويقدم وصفا بديعا للأشجار المحملة بالثمار، والمياه المنسابة بين الحصى، والطيور المترنمة بأعذب الألحان، وكأنه يدخل عالما سحريا.
ولعل حديث الشاعر إلى حصانه يكشف لنا جانبا من روعة المكان الذي تعدى تأثيره الإنسان إلى الحيوان الذي لا يعقل، فقد جعل المتنبي من حصانه ندًّا محاورا يحثه على البقاء في الشعب، ويذكره بالخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة.
ويتجاوز الشعراء التغني بجمال الطبيعة ، ووصف الربيع و الرياض الغناء إلى الاهتمام بالأزهار والورود، والحديث عنها ضمن غرضي الغزل و المدح،
ومن الشعراء الذين اشتهروا بوصف الورد ابن المعتز وعلي بن الجهم، يقول هذا الأخير في إحدى قصائده:
لَمْ يَضْحَكِ الوَرْدُ إِلَّا حينَ أَعْجَبَـــهُ ** حُسْنُ النّباتِ وَصَوْتُ الطّائِرِ الْغَرِدِ
بَــدَا فَأَبْــدَتْ لَنَا الدُّنْيَا مَحَاسِنَـهَــا ** وَرَاحَتِ الــرَّاحُ فِي أثْوابِــهَــا الْجُـــدُدِ
لقد احتل الورد وأنواع الأزهار مساحة وافية في الشعر العباسي، والطريف حقا هي تلك المقارنات والمفاضلات التي أجراها الشعراء بين أنواعه؛ فمنهم من تعصب للنيلوفر، ومنهم من أشاد بالبنفسج، والبعض فضل النسرين والريحان. وتتجلى مدونة الورود والأزهار في الشعر العباسي ثرية، وحافلة بالطريف والممتع، ويجري توظيفها في غرضي الغزل والخمر توظيفا بديعا، ومنه قول أبي نواس -على الأرحج-:
وَحَمْـــرَاءَ قَـبْــلَ الْمَــزْجِ صَفْــرَاءَ بَعْـدَهُ ** بَــدَتْ بَـيْــنَ لَـوْنَـيْ وَرْدَةٍ وَشَـقَــائِـــقِ
حَكَتْ وَجْنَةَ الْمَحْبُوبِ صِرْفًا فَسَلَّطُوا ** عَـلَـيْـهَـا مِـزَاجًا فَاكْتَسَـتْ لَوْنَ عَاشِـقِ
ويمتد الحديث ويتشعب لو تطرقنا إلى الطبيعة في الشعر الأندلسي، فلذلك وقفة ووقت آخر بحول الله.