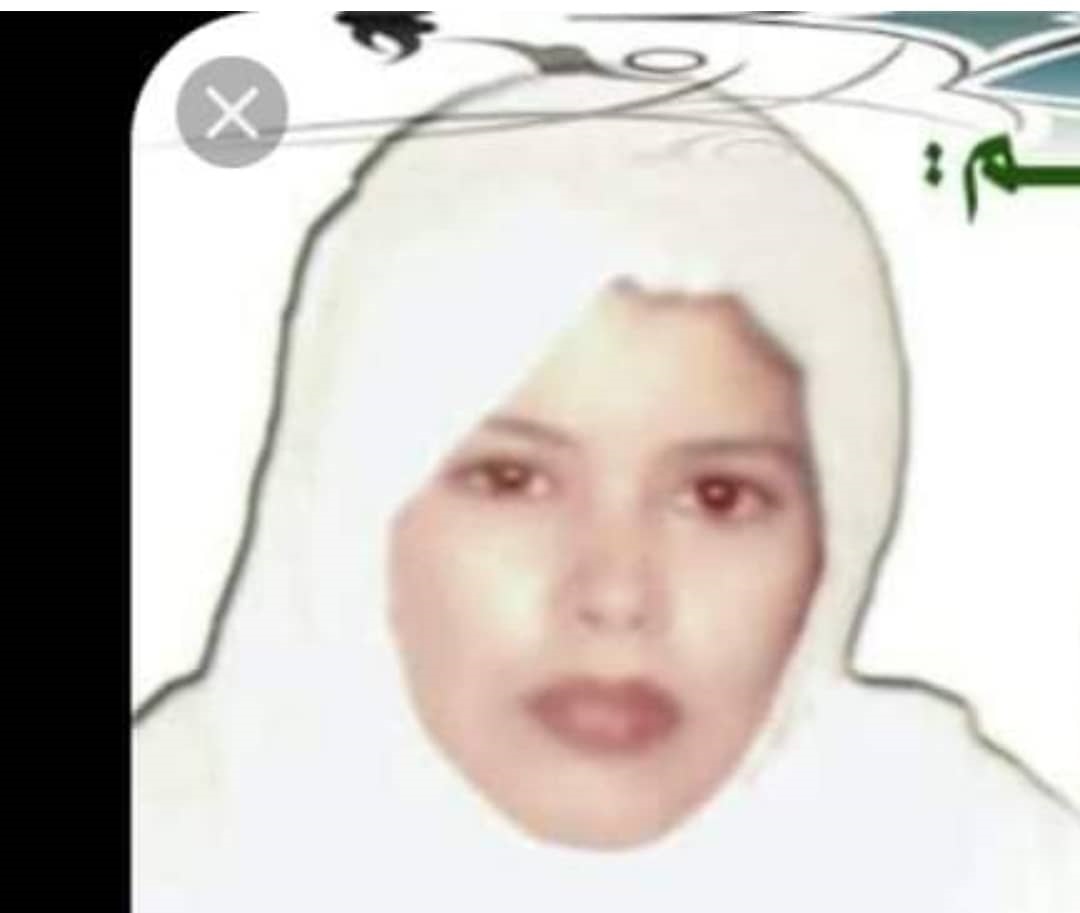محمد محمود مولاي الزين
بينما كنت أخرج من المطعم متجهًا إلى الفندق، مثقل الرأس بالأسئلة والقلق، صادفتُ ثلاثة شباب بملابس أنيقة. من ملامحهم وطريقة حديثهم عرفتُ فورًا أنهم موريتانيون. لم يكن اللقاء صدفة عابرة، بل كأن الطريق أراد أن يقول لي: لن تمشي وحدك.
كنتُ قبل دقائق، وأنا جالس في المطعم، غارقًا في التفكير في الخطوة الثانية: كيف أصل إلى كولومبيا؟ ومن هناك… كيف أواصل الطريق نحو الحلم الأمريكي.
أحد الشباب كان يجيد اللغة البرتغالية، وهي قريبة من الإسبانية، فكان وجوده طمأنينة وسط هذا الغموض.
جلسنا نتحدث. عرضتُ عليهم العشاء، فرفضوا بلطف. كانوا طيبين، بسطاء، يحملون نفس الهم ونفس الهدف: الهجرة إلى أمريكا. سألتهم إن كانوا يعرفون أحدًا داخل الإكوادور، فأجابوا بالنفي. عندها تذكرتُ رقم أحد المهربين كان بحوزتي.
تواصلنا معه، وتولى الشاب الذي يجيد البرتغالية الحديث. قال لنا المهرب:
اذهبوا إلى المحطة الفلانية، اشتروا تذاكر من هناك.
لم نتردد. ركبنا باصات قديمة، رحلة دامت ست ساعات. كان الخوف يسكنني، ليس من الطريق فقط، بل من المجهول الذي ينتظرنا في نهايته.
وصلنا إلى الحدود. تواصلنا مجددًا مع المهرب، وطلب منا الذهاب إلى فندق محدد. في الليل جاء بنفسه، استلم 150 دولارًا من كل واحد، ثم جاءت سيارات أجرة أقلّتنا إلى نقطة أخرى.
هناك، شاهدتُ نوعًا مختلفًا من سيارات الأجرة، تابعة للمهرب.
تحدث السائق مع الشرطة الكولومبية، ناول أحدهم شيئًا بيده، وفُتحت الطريق دون أن يُطلب منا جواز سفر أو يُسأل عن أسمائنا. في تلك اللحظة، أيقنتُ أن القانون هنا يُشترى، وأن حياة المهاجر لا تساوي أكثر من ورقة نقدية.
وصلنا إلى منزل قديم، مرعب، كأنه خارج من فيلم رعب. انتظرنا فيه ساعات طويلة. الصمت كان ثقيلًا، والخوف يتسلل إلى الصدور دون استئذان.
جاء المهرب مجددًا وطلب من كل واحد منا 300 دولار ليُوصلنا إلى حدود بنما. دفعنا المبلغ دون تردد. أحضر لنا بعض الطعام وقليلًا من الماء. كنا نأكل ونحن نعلم أن القادم أصعب.
المفاجأة الكبرى كانت حين وصل الباص الكبير. عشرات المهاجرين الأفارقة، وجوه متعبة، عيون فقدت الدهشة.
كان حظي أني وجدت كرسيًا أجلس عليه، بينما بقي كثير من الإخوة واقفين. كنت أتناوب معهم على الكرسي.
الضجيج كان خانقًا: موسيقى صاخبة، أصوات عالية، وسائق متهور لا يعرف الرحمة.
وحين ذهبت إلى الحمام… كان مقرفًا إلى درجة أنني لم أتمالك نفسي.
الرحلة طالت. يومان كاملان تقريبًا.
وما زاد الألم أن الشرائح التي أعطانا المهرب لم تكن مفعّلة. انقطعتُ عن أهلي يومين كاملين. لا صوت، لا رسالة، لا طمأنة.
كنا نعبر جبال كولومبيا، وكلما نظرتُ من النافذة شعرتُ أن الباص سينقلب بنا في أي لحظة.
كنت أسأل نفسي مرارًا:
لماذا أهاجر؟ لماذا أختار هذا الطريق؟
بعد 24 ساعة دون نوم، غلبني التعب، فنمتُ ست ساعات متقطعة.
وصلنا إلى ميديلين… مدينة إسكوبار. تذكرتُ تاريخها الأسود، بابلو إسكوبار، الدم، المخدرات. وكأن المكان يحمل ذاكرته الثقيلة حتى اليوم.
بعد ساعتين، توقّفنا. الطريق مسدود.
انتظرنا قرابة خمس ساعات. السبب؟
معارك عنيفة بين تجار المخدرات والشرطة والجيش الكولومبي.
قلت في نفسي:
هل يمكنني الرجوع؟
لكن الطريق إلى الوراء كان قد أُغلق منذ زمن.
حين خرجنا من ذلك الجحيم، تحدثتُ مع سائق الباص، أعطيته 50 دولارًا ليُفعّل لي شريحة الهاتف.
عملت أخيرًا… الإنترنت بطيء، لكن القلب أسرع.
اتصلتُ بوالدتي.
سمعتُ صوتها… وكدتُ أبكي.
كذبتُ عليها، قلتُ إن كل شيء بخير، وإن الطريق سهل، وإنني بخير.
الكذب على الأم أصعب من الطريق كله.
قال لنا أحد السائقين:
بقيت ست ساعات فقط وتصلون إلى وجهتكم.
تواصلنا مع المهرب، وكان اسمه لويس.
في الحقيقة، كان شابًا طيبًا مقارنة بغيره. استقبلنا، وأخذنا إلى مكان الإقامة. سألنا إن كنا نريد فتيات للسهر.
أجبناه بهدوء:
هذا محرّم علينا شرعًا.
احترم جوابنا، وتركنا نرتاح قليلًا.
لكن…
كنا نعلم جميعًا أن الراحة هنا مؤقتة، وأن الطريق لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
يتبع