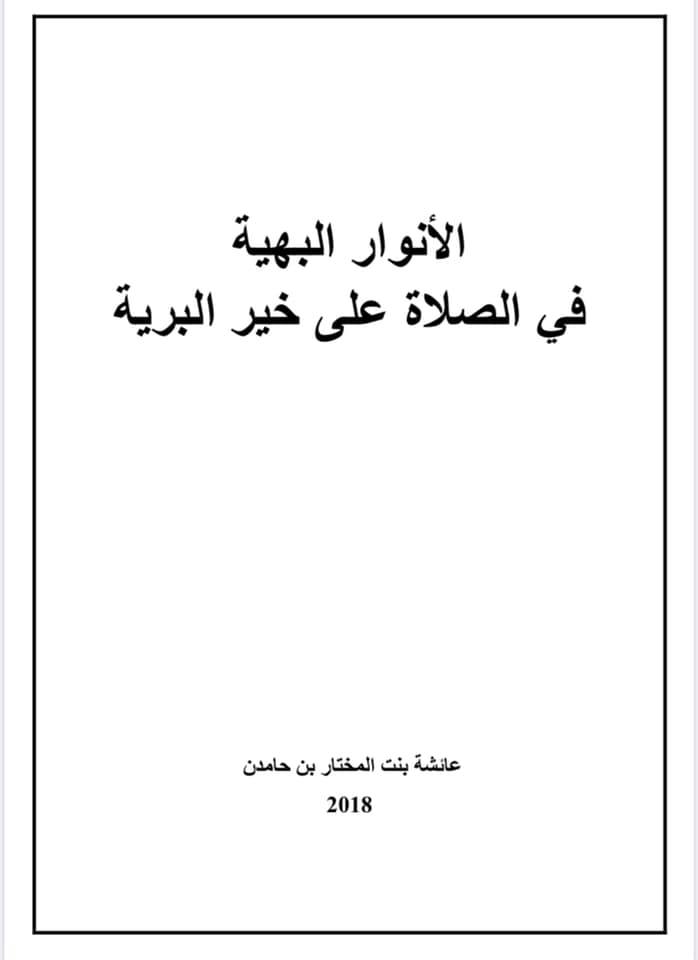حين أزور المغرب في العقد الأخير، كنت أتوجه رأسا إلى الرباط، المدينة التي ألفتها، كما لو أنني عشت فيها أيام صباي، كتبت عنها مرة بأنها "تحفة الشاطئ اللازوردي"، وتخيلت أنني على بعد خطوات من المكان الذي وقف به عقبة بن نافع، يناجي البحر: " أيها البحر..."، وتمنيت حينها في قلبي لو أن بلدية الرباط أقامت تمثالا لهذا الفارس العربي الذي أوصل الدين الإسلامي لهذه الربوع... أشرت في هذا المقال الخاطرة إلى أنني أحببت هذه المدينة التي لاتفتأ تجدد نفسها، وتخترع صورة جديدة للجمال.(نشر المقال في صحيفة أخبار اليوم المغربية).
هذه السنة سبقتني الأسرة إلى المغرب واختارت أن تتفيأ ظلال منارة مسجد الحسن الثاني طيب الله ثراه، وأن تقيم في مدينة "كازا بلانكا.." وموسيقى العبارة تغري بكتابتها، وإعادة النطق بها، ربما لعلاقة غامضة بين إشباع المد المفتوح، وتحرر الشفتين من معانقة بعضهما. لمرات عديدة أقمت أياما في هذه المدينة التي لا تبوح بسرها إلا لمن أقر للعمالقة بخاصية التفوق، لكنني لم أطمح للحصول على سر هذه المدينة الساحرة لأن ذلك يقتضي ألفة وعشرة لا يسعهما الزمن التعاقبي، إنما تنسم المكروب ذرات الضباب التي تلف المدينة عادة (اسمها الذي أحببته باللهجة المغربية "أضبابا..")، ليملأ رئتيه بعبير التاريخ، ويشهد مع الذين طمعوا في الاستحواذ على عبق "أضبابا.." أنهم واهمون؛ هذا التنسم يمكن أن يقود إلى التساؤل عن السر، والتساؤل يمكن –ربما- أن يقود إلى مناجاة مع البحر الذي قد يبوح بالسر، وقد يشغله إعادة بناء موجه المسكون باللغط، وإعادة صناعة الزبد وتبديده.
سمعت لأول مرة بكلمة الدار البيضاء وأنا في السادسة من عمري، من أحد الشيوخ الموريتانيين يدعى محمد بن آبَّوَّ، كان أديبا وشاعرا، وتلميذا مادحا لآل الشيخ ماء العينين، وصديقا للمرحوم علال الفاسي ، وقد كان يستنشده رجال في قريتي، فينشدهم من شعره أبياتا يحن فيها إلى بلده، يذكر فيها: " وما لي الدارة البيضاء بالداره" حينها كان يسكن بالدار البيضاء مدرسا للحديث..
ألهب هذا الشيخ خيالي وسكن الإسم في ضوضاء خيالي الغض، فكنت معلقا بهذه المدينة إلى أن زرتها في بداية الألفية، فأدركت سبب برم هذا الشيخ البدوي الذي ألف البادية وخيمها المتناثرة، وصحاريها الشاسعة، ولياليها الحالمة،وأسرارها المبثوثة؛ فإذا به محاصر داخل مدينة عملاقة،لا يكفى التاريخ كله للإحاطة بمكنونها.
هذه المرة قبلت أن أكون بيضاويا، مع حق الاحتفاظ برباطيتي التي لا أتخلى عنها بسهولة،
وبدأت أتسقط الأخبار والمعالم، وزرت معلمة بكازابلانكا يصعب على من زار هذه المدينة أن لا يتوقف عندها، إنها معلمة يعانق فيها الفن والجمال والإبداع المغربي الأصيل، البحر بكل عنفوانه وقدرته على إعطاء ألوان الزرقة والغموض والتنوع بهجتها، إنها مسجد الحسن الثاني، حين صليت في هذا المسجد صحبة الأطفال سألني أصغرهم وهو في الخامسة من عمره، هل الحمام هو الذي صنع هذه الزخرفة الجميلة على الأبواب والجدران؟ كان يطرح سؤاله وهو يتابع حمامة قمري ترفرف بجناحيها؛ تتسلق فرجة بجدار المسجد.
.. طبعا لم أجبه على سؤاله، وإنما طرحت على نفسي سؤالا كدت أن لا أخرجه من مخدعه.. من أي خبايا الروح أخرجت فكرة تصميم، وتشييد، وتجميل وتطريز هذه المعلمة الرائعة، وكيف استطاع هؤلاء العباقرة المغاربة،أن "يعربنوا"هذا العناق الأسطوري بين تحفتهم الحسنية، وبحر الغموض والعجائب والظلمات..
إنها فكرة عبقرية، أخذت بمجامع قلوب السياح من كل جنسيات العالم الذين يصطفون جماعات ووحدانا، يصورون ويستمتعون، ولا اشك أنا في أنهم يغارون منا نحن المسلمين الذين استطعنا بعبقرية ملك منا، وموهبة مهندسينا أن نصنع هذه العجيبة...
الأمل قائم ونحن نستطيع إذا تملكنا الإرادة ومن يقودنا إلى الإبداع والابتكار، أن نصنع كل أسباب نهضتنا المتعثرة منذ قرون...
محمد الأمين أحظانا
كاتب وروائي موريتاني، خبير إعلامي معتمد