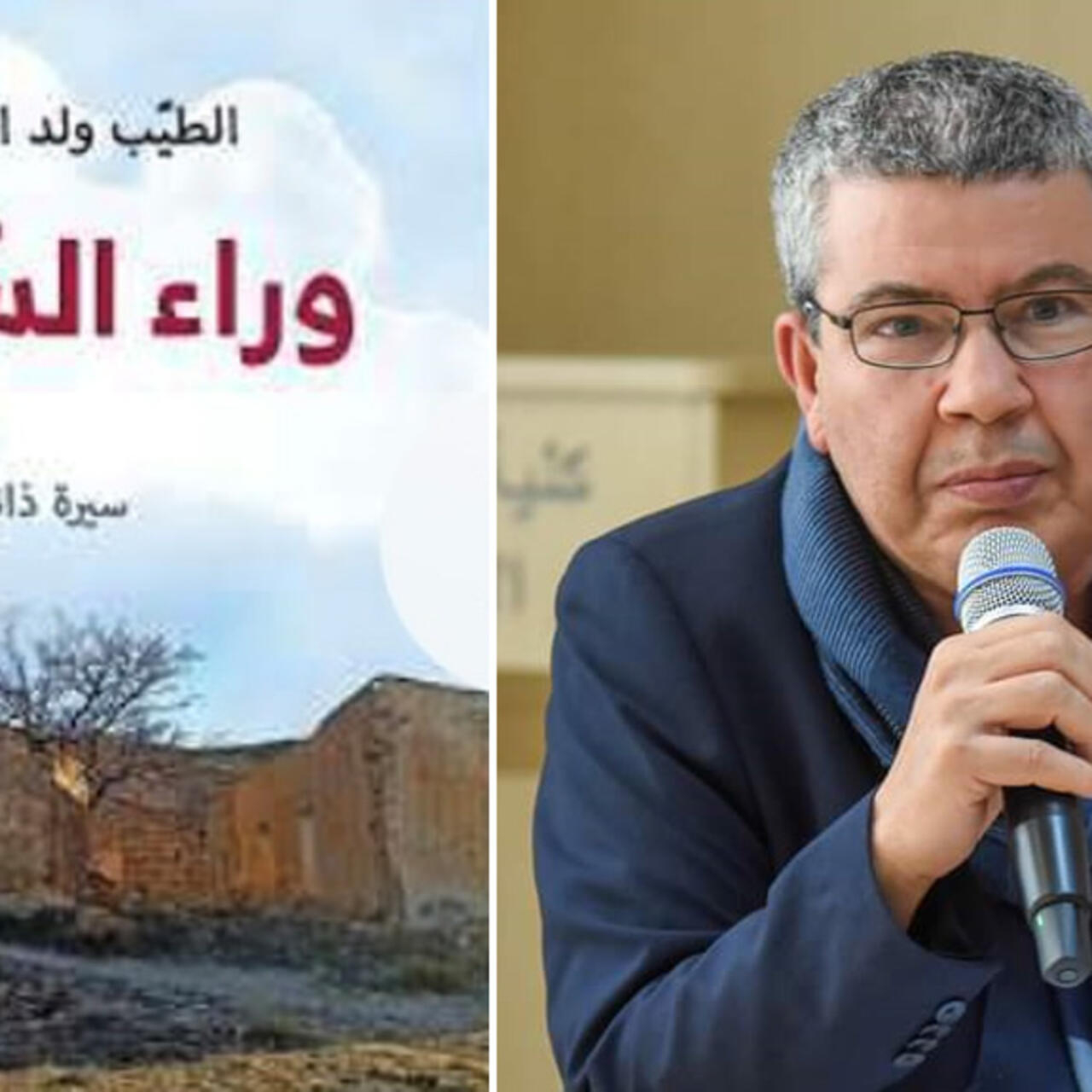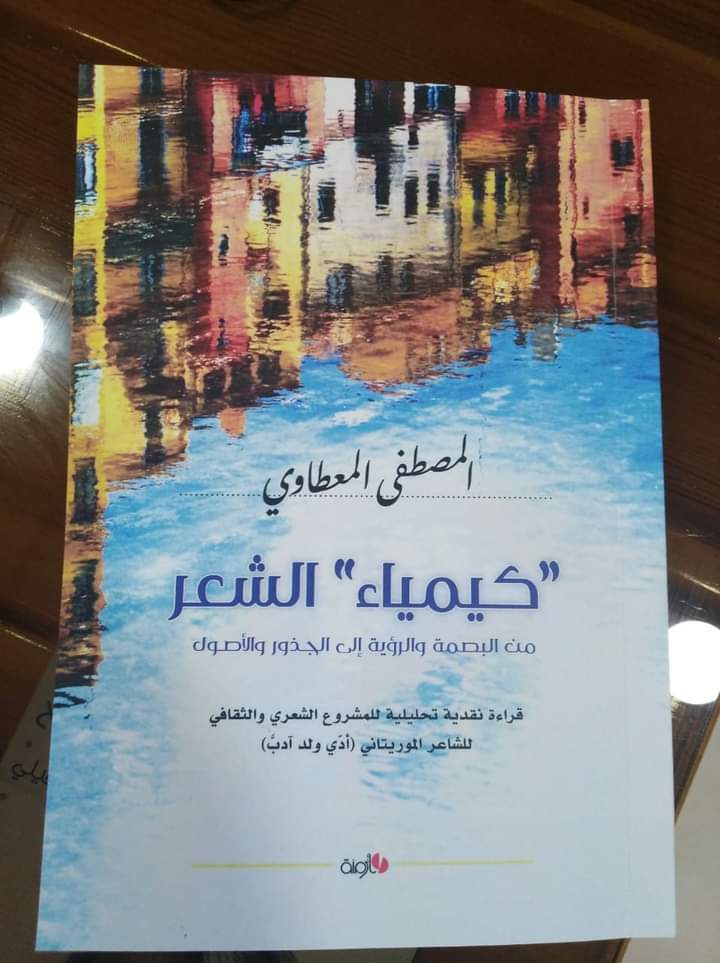
جدل الطبع والصنعة
ذ- المصطفى المعطاوي
"في كتابنا «كيمياء الشعر» الذي تناولنا فيه التجربة الثقافية والشعرية للشاعر الموريتاني أدي ولد آدب، ختمناه بعبارة تؤكد على ضرورة تجاوز هذا الكتاب نقديا، وعنينا بالتجاوز الانطلاق من مخرجاته إلى آفاق جديدة لم يتحملها الكتاب منهجا ورؤية، ثم سكتنا بعد ذلك. في هذا المقال والمقالات التي تليه تباعا نعرض على القارئ بعض تلك الآفاق الواعدة لهذا المشروع المفتوح.".
كتب الشاعر العربي عن طبع، إذ الشعر هو لغة القوم في التداول، ونقصد بذلك حياة العربي في السلم والحرب والأعراس والأعياد والمآتم والحل والترحال والعلاقات الاجتماعية والمواقف السياسية، وحتى في علاقة العربي مع الطبيعة ومكوناتها.
الشعر هو لغة التعبير، وإن لم يكن كل عربي شاعرا، فكل عربي متلق للشعر، يفهمه ويستسيغه ويتفاعل معه وينفعل به ويقومه في الوقت نفسه، بما يظهر كأنه مستوى نقدي فطري قائم على الذوق المستمد من حياة العربي نفسه، وطبيعة عيشه وتقاليده وأعرافه، وما إلى ذلك.
ولما بدأ نقد الشعر يتشكل كموضوع ثقافي ضمن مواضيع الثقافة العربية الإسلامية، كانت البداية فيه بتلك الحقيقة، فالجاحظ صاحب البيان والتبيين يقول إن كل شيء للعرب بديهة وارتجال وأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ... وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام... فتأتيه المعاني إرسالا وتنثال عليه الألفاظ انثيالا". لكن بعد الجاحظ، وبعد الوقوف على بعض الظواهر في إنتاج النص الشعري، بدأ الحديث عم مفهوم «الصنعة»، وتم اعتبار زهير بن أبي سلمى أول من تصنع في الشعر، ومعنى ذلك عند ابن رشيق القيرواني أنه كان يصنع القصيدة، معتبرا أن مكوثها عنده حولا كاملا قبل أن تداع كان بغاية التنقيح والمراجعة. وهذا أمر جديد على الشاعر العربي الذي عرف بارتجاله الشعر دون أن تفقد القصيدة قيمتها الفنية والجمالية. ثم توالت بعد ذلك الكتابات في مسألة الصنعة، فكتب فيها ابن قتيبة والقاضي الجرجاني وأبو إسحاق الحصري وغيرهم، وقد أنتجت العديد من المفاهيم النقدية حول الموضوع، مفاهيم تم استثمارها في عصر النهضة العربية لبلورة رؤية جديدة لمفهوم الشعر من جهة، وللقصيدة العربية من جهة أخرى، وهذا موضوع رعفت فيه أقلام كثيرة ولا زالت، لكن الذي يهمنا هنا هو أن نطرح تصورنا لمفهومي «الطبع والصنعة» وتجلياتهما في التجربة الشعرية للشاعر الموريتاني أدي ولد آدب. ولأن توجهنا بياني بامتياز، فالأقرب إلى تصورنا في الثقافة البيانية العربية هو ما ورد في قول القاضي الجرجاني إن «الشعر علم من علوم العرب»، وهذه عبارة ثاقبة لأنها رؤية جمالية بأوسع نطاق، وإن كانت قديمة تاريخيا إلا أنها حداثية فنيا، ذلك أنها تخرج بالشعر من مجرد تعبير لغوي إلى تعبير جمالي، مما يعني اشتراكه في تلك الجمالية مع ضروب الفن الأخرى؛ من هندسة ومعمار ونحت وتشكيل وموسيقى وغناء... الخ. لقد أدرك القاضي الجرجاني هذه السمة الشمولية لفن الشعر حين رأى أنه يجمع بين الطبع والرواية والذكاء، وهو ما يمكن تسميته بلغة اليوم الموهبة والثقافة والفكر، وبعيدا عن الجدل القائم بين هذه العناصر الثلاثة، وأيها يشكل الآخر ويتشكل به، نقول إن القاضي الجرجاني قد تجاوز سابقيه وبعضا ممن أتوا بعد في تصوره لموضوع الشعر، فلم يكتف بالعناصر تلك، وإنما طرح مفهوما جديدا هو نواة ومركز الرؤية حين اعتبر أن تلك العناصر تحتكم إلى «الدربة»، باعتبارها مادة الشعر من جهة، وقوته من جهة ثانية. والدربة في التعبير المعاصر هي الخبرة بلا شك، وإذا أردنا أن نسافر سفرا قصيرا عبر تاريخ الفن بشكل عام، فإننا نرى أن كل الفنون تطورت ذاتيا إما عبر المثاقفة أو من خلال الابتكار، ففن التشكيل - مثلا - تطور من الطبيعي إلى التكعيبي إلى الرمزي إلى السريالي إلى غير ذلك من الأشكال، وقد حدث هذا التطور إما من خلال مبتكرين ذوي موهبة، أو من خلال تقاطع فني مع الفنون أو العلوم الأخرى، مما تعود أسسه إلى الفكر أو الثقافة، وفي كل الأحوال فكل منتوج جديد إنما يقوم على تراكم الخبرات، وهذا هو حال العلوم في حقيقة الأمر، وهو ما عبر عنه القاضي الجرجاني في كلمته التي أوردناها سابقا.
صنعة الشعر لا تناقض الطبع، وإنما هي جزء أصيل فيه، هذا ما أراده الجرجاني، وهذا ما نؤمن به، وهو منطلق القول في تجربة الشاعر أدي ولد آدب، وإذا كان لكل فن خطاب يحدده ويتحدد من خلاله، فنحن نرى أن جانبي الطبع والصنعة – وهذا هو الجديد- إنما يتحدد بعناصر محددة في الشعر العربي الحديث، وهي اللغة والإيقاع والصورة والرمز. كيف؟
إن لغة القصيدة الحديثة لم تعد لغة معيارا، لأنها كسرت معيارية التعبير القائمة على الجزالة والشرف وغيرها من المصطلحات التي وصلتنا من الحقبة القديمة، وإيقاعها تمت خلخلته منذ عصر النهضة،فتشكلت إيقاعات جديدة هي في خلاصة القول إيقاعات الحياة المعاصرة التي كانت نتيجة للمثاقفة في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة والمستويات، وهو الأمر نفسه الذي حدث على مستوى التصوير، لأن تغير لغة التعبير يعني تغيرا في مستوى التصوير وشكله وطريقة بنائه، بما يتوافق مع اللحظة الراهنة التي تميزت بمورد ثقافي كان محطة انبهار الفنان العربي عموما بالمتقدم الغربي، ومنه الشاعر على وجه الخصوص، وهي ظاهرة طبيعية في التحولات التاريخية على وجه العموم، أما الجديد في القصيدة العربية الحديثة هو وقوفها على الرمز كشكل من أشكال التعبير الفني والجمالي، وهو ما لم تراهن عليه القصيدة العربية قديما لعدم حاجتها إليه، ليس فنيا فحسب وإنما حضاريا أيضا.
بعد بسط هذا الرؤية نقول إن المائز في التجربة الشعرية لأدي ولد آدب يمكن تحديده من خلال العناصر التالية:
أولا: لغة القصيدة ما بين المعيارية والتداولية.
ثانيا: الصورة الشعرية في الأفقين البياني العربي الموروث والجمالي الإبداعي المبتكر.
ثالثا: إيقاع النص الشعري بين الانسيابية الفطرية والتشكيل المستحدث.
رابعا: الرمز الفني في شقيه البلاغي العربي والاستعاري الثقافي.
لقد قرأنا تجربة الشاعر أدي ولد آدب بما نظن أنه يمنحنا الحق في إصدار تقرير عام، تستطيع أية دراسة نقدية خاصة دقيقة وعلمية أن تؤكده أو تنفيه، ويقوم هذا التقرير على ما يلي:
1- جمع الشاعر بين لغتين؛ معيارية تنتصر للموروث الشعري العربي القديم، وتداولية تراهن على الإيحاءات المعاصرة للفظة العربية، مما نراه خلخلة داخلية للكلمة العربية، وهي خلخلة غايتها التذكير بأن اللفظة العربية القديمة لم تخلق لتبقى قديمة، وإنما هي لفظة تاريخية تحتاج إلى مبدع، وإلى مبتكر له وعي لغوي قادر على إدراك عنصر الحياة فيها، والاشتغال عليه، ومن ثم بسطه للمناقشة والتطوير. لقد ارتبط مصطلح «الكرم» مثلا عند العربي بقرب وفوقية المانح من الممنوح، لكن في شعر أدي ولد آدب تتغير الدلالة، وذلك ببعد المانح عن الممنوح وبفوقية الممنوح عن المانح. تلك رؤية جديدة لعبارة قديمة.
2- ظلت الصورة الشعرية في القصيدة العربية التقليدية صورة بصرية، بمعنى أن القارئ يمكنه تجسيد تلك الصورة والنزول بها إلى الحس لفهم تعالقاتها الفنية والفكرية، وفي القصيدة العربية الحديثة ثم الانتقال بالصورة إلى مستوى تجريدي، بحيث لا تتجسد الدلالة بصريا، وإنما ذهنيا، وفي كثير من الأحيان تحتاج إلى ثقافة واسعة من المتلقي لفهم الدلالة، إذ تتشكل الصورة خارج البيان العربي المألوف، وكأن هذا البيان غير قادر على خلق انزياح مماثل يمنح للصورة الشعرية الدلالتين معا: البصرية والذهنية. في شعر أدي ولد آدب تمتلك الصورة الخاصيتين معا البصرية والذهنية، فهي تتشكل من لغة القوم وبيانه وطريقته في التعبير، لكنها بالمقابل تسافر به نحو دلالات غير مألوفة لديه، لقد جرى في البيان العربي تشبيه الكريم بالعارض أي الغيمة المطيرة، ومن ذلك قول المتني في سيف الدولة:
العارض الهتن بابن العارض الهتن ابـ ـن العارض الهتن ابن العارض الهتن
هنا الغيمة مرادفة للكرم، وبالنظر إلى المكرِم الفاعل والمكرَم المفعول، فهذ الأخير ينتظر نزولها، إن الصورة تضع الكريم في مقام فوقي عن المكرَم، لكن إذا كان الكرم سجية العربي وطبعه وجبلته فكيف يتعالى به؟ إن الأصح أن يكون صورة لمستوى طبيعي في شخصيته، إنها صورة جديدة يقف عندها أدي ولد آدب حين يعتبر نفسه غيمة لا تهطل تكرما على الإنسان وإنما محبة له، هنا يتساوى الكريم والمكرَم، بل يضع الكريم نفسه بمنزلة أدنى لتنتقل دلالة الغيمة من التصور العربي التقليدي الذي يمثل ثقافة حقبة ما في وسط مجتمع ما إلى تصور جديد تحتاجه البشرية اليوم.
3- على مستوى الإيقاع، ونستعرض هنا تصور أدي ولد آدب لعلاقة الإيقاع بالنهر، واسع عريض، بين ضفتيه ينساب الماء انسيابا، وضيق الضفتين تختنق فيه أثناء التدفق المياه. كيف؟
إن الذي يفهم إيقاع الشعر على أنه تشكيل لصوامت وصوائت لغوية انطلاقا من قانون محدد سلفا، فهذا لن ينتج إلا قصيدة يضيق بها صدر المتلقي، لأن الفن ليس تجسيدا لقاعدة رياضية، وإنما هو تجسيد لقاعدة جمالية؛ الأولى مرفوضة إذا تجاوزت المنطق والعقل، والثانية مرفوضة إذا لم تطور نظرتنا إلى المنطق والعقل، الأولى أسيرتهما بالضرورة العلمية البحتة، والثانية تجددهما انطلاقا من الضرورة الجمالية الصرف. والمتأمل في إيقاعات النصوص الشعرية لأدي ولد آدب يراها تجسد هذه القاعدة الجمالية الأخيرة، وهذا هو سر التنوع الإيقاعي في قصائده، فلا هي أسيرة للنظام الخليلي القديم، ولا هي مستوردة للإيقاعات المستحدثة، لكنها بنت إيقاعاتها الخاصة مما هو أوسع نطاقا وأرحب فضاء، استوردت إيقاعاتها من إيقاعات الكون؛ ريحه وموجه وكائناته...في حيويتها الدائمة، منظورا إليها وفيها من خيال رحب لا من واقع مألوف ومتكرر.
4- وأما المستوى الأخير في هذه التجربة فيتعلق بالرمز الشعري، ونحن هنا نميز بين الرمز البياني الذي طبع كل القصائد العربية على مر التاريخ، وهو رمز مستمد من العالم وأفق الرؤية التي فرضتها الحياة وتقلباتها على الشاعر العربي منذ العصر الجاهلي، وبين الرمز الفني المستحدث الناتج عن مستويات المثاقفة بين الشاعر العربي والثقافة الإنسانية في عمومها، لم يكن الشاعر العربي قديما على جهل بمن سبقته من الثقافات القديمة في العالم غير العربي، وهذا ما أثبتته الدراسات التاريخية المقارنة، لكن هذا الشاعر العربي لم يكن في حاجة - لظروف اجتماعية وحضارية - إلى أن يستمد من ثقافة الآخر ما يبلور فنيا تجربته الشعرية، وإدراكه لعدم الحاجة تلك هو ما جعل القصائد العربية قديما خالية من رموز خارجية ذات دلالات وجدانية واجتماعية وإنسانية وغيرها... أما الشاعر العربي المعاصر، ونظرا للتصورات الجديدة حول مفهوم الشعر، خاصة تلك المستمدة من الثقافة الغربية – ولا نرى فيها عيبا إذا تم الاشتغال عليها انطلاقا من فهم كوني للفن والجمال والإبداع لا في مستوى من مستويات التقليد ضيق الرؤية-؛ الشاعر العربي رأى أن توظيف هذه الرموز يمكن أن يمثل إضافة نوعية للقصيدة العربية، ومن ثم استكمالا للرؤية العربية حول مفهوم الشعر، ونحن نرى أنه أمر لا يخالفه إلا ضعيف البصيرة الفنية والجمالية؛ وهذه الرؤية تحديدا نجدها في التجربة الشعرية لأدي ولد آدب، ذلك أنه جمع في التصوير بين الرمزين البياني العربي والثقافي الكوني دون أن تكون لهذا سلطة على ذاك، أو أن يكون ذاك أقصاء لهذا، فالتعبير عن الطغيان يمكن تصويره من خلال الرمز «هولاكو» كما يمكن تصويره من خلال مشاهد الدمار في سوريا والعراق وفلسطين، والتعبير عن محبة الشاعر للإنسان يمكن تصويرها من خلال الغيمة كما يمكن تصويرها من خلال مغامرة «السندباد وكريستوف كولومب»، لأن المسألة تتجسد دلاليا في رحلة بحث.
هكذا ترتسم أمامنا التجربة الشعرية لأدي ولد آدب جامعة بين جدل الطبيعي والثقافي، جدل الفطرة والاكتساب، جدل السليقة والصنعة، جدل الأصالة والمعاصرة، جدل البيان والابتكار، جدل القديم والحديث، جدل أفقي عمودي، تاريخي ثقافي، نقدي فني؛ يكمل ولا يلغي، إنها صورة لمفهوم الفن القائم على التوسيع والتجديد دون الإلغاء أو الإقصاء.
_______
مواد ذات صلة: