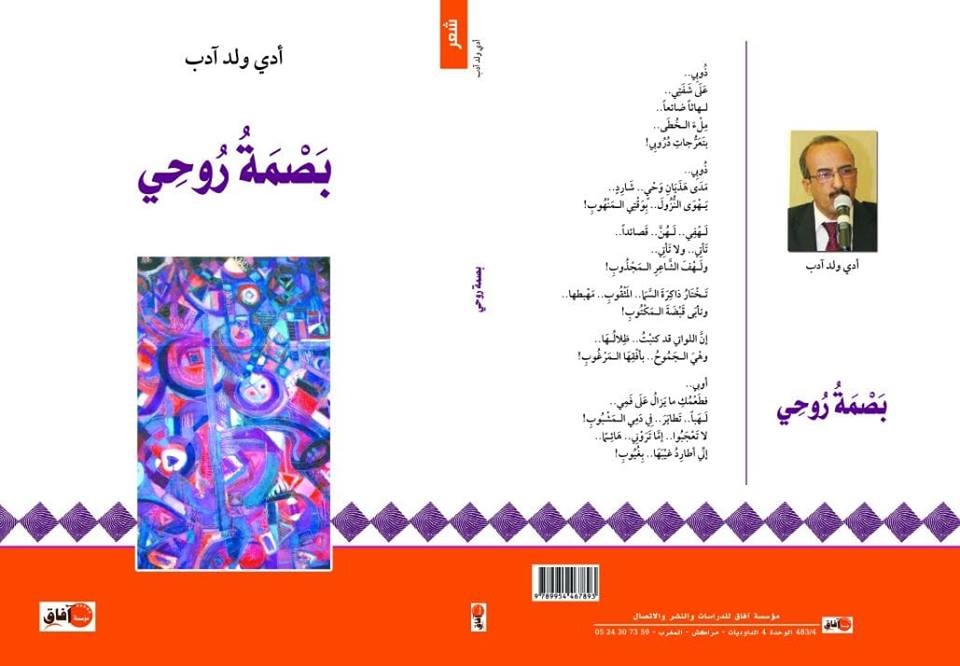ماري- فرانس هينريش، أو مريم.
.....ا
بصوت مُرتبك مُتهدّج هاتفني آمادو قائلا: توفِّيت السّيدة حالاً!،..
الوقت يشير إلى صوت الإقامة من صلاة الجمعة، لحظة لن تكون رتيبة.. كان مصدوما، يكرّر باستغراب أنَّها تناولت من يده قبل نصف ساعة كوب ماء وقطعة مانجو، وكانت تستعد لأخذ حمام، طمأنَتْهُ ليذهب إلى الجامع قائلة: أصبحتُ بخير بَدنيًّا، لكنَّ حدسي يشعرني بشيء مَّا!.. فعلًا، لم تخذلها آخر طلقة تخمين في حياتها، جارت إشارة الحدس واسلمتِ الروح...
هذا الناموس الكوني غير ملزم بتقديم مُمهِّدات منطقية أو مُتشابهات نمطيَّة!.. قد نروِّض المرض، لكن لا ترويض للموت، والحياة مَسيرة تتقدم نحو نهايتها.
تشابكت خطوط الهواتف بين ثلّة من أصدقائها، وبين قنصلية بلدها فهي مواطنة غربية، ويترتَّب على رَبعها إخلاء ذمتهم الدبلوماسية بشهادة موت طبيعي..
أمام بيت الرحمة بالمستشفى الوطني، كنت برفقة صديقتين ننتظر الافراج عن الجثمان، تثاءب الوقت، وتمططت الدقائق لتنافس الساعات طولا، ترجلتُ من سيارتي اتجاه الحالات المستعجلة حيث عناصر القنصلية ينازلون الروتين،.. على مقعد طويل في المدخل تراصَّ بعض أصدقائها، كهل من وولوف وبولاري سائقها، وصديقها الأقرب الصحفي الخلوق موسى صمباسي، وكان منشغلا بتحرير البيان رقم واحد لوضعها الجديد: الموت!، فكتب لمعارفها: توفيت للحظتها ماري- فرانس هينريش.
تحاول القنصلية ضمان توديع لائق يشمل دفنها في المربَّع الخاص بالموتى من المسيحيين، لكن موسى أنبأهم أنها مسلمة وأوصت بدفنها في مقابر المسلمين، وكنت بدوري أعلم أنها آوت إلى ذلك الركن.
وصلت الحافلة لبيت الرَّحمة، غيْر أن خازن البيت يحتكر على ما يبدو رحمة المعاملة، أخبرنا بحجزه لموتى المستشفى،.. ارتأى بعض رفقتي التوجه لمجسد الرابع والعشرين، واقترحتُ عليهم مسجد بدّاه بلكصر، فقبلوا.
سرتُ وراء الحافلة العتيقة، تتمايل منزوعة الباب الخلفي، وجثمان صديقتي الذي حُرِّر لحظته من الرُّوح مسجى فيها، وقد لُفَّ في بطانية،.. طاف بخاطري تصريف الأقدار، تخيلتها تخرج من مشرحة نظيفة في بلدها، تفوح منها رائحة المعقّمات، وقد أخذت مكانها في تابوت أنيق من خشب الصّندل، مُبطَّن بالدانتيل الأبيض، تزفُّها سيارة سوداء مظلَّلة النَّوافذ إلى مقبرة خضراء، ندية العشب، جيرانها من ساكنة الأبدية يغلفهم رخام رمادي، نقشت عليه الأسماء بأناقة، وتحيط بهم المزهريات .. فهل أرادت صديقتي موتًا متواضعا إلى هذا الحد؟،.. نتوقف كثيرا عند الكلمة الأولى لما بعد الحياة : الموت!..
وصلْنا إلى مسجد بداه دقائق قبل أذان المغرب، وهناك عُوملت كمسلمة، ثم تولى موسى بقية أمرها، وقد أوفى وأكرم وكان صديق إگفَ.
مريم!.. الناس كالكتب بعضها يجذبك بالعنوان، لكن تعجز أن تواصل معه لأبعد من المقدمة، وبعضها يبدو بعنوان غير مُغرٍ، ثم يوصلك المحتوى بشغف للفصل الأخير،.. أقلِّبُ بين يديَّ جثمانا هو آخر صفحة من آخر فصل من حياتها.
سيدة رَسَت على الثمانين، تكره إراقة الوقت، تعطي انطباعا بقوة البنية، فارعة الطول، شديدة النشاط، كأنها شكلت من بطاريات مشحونة،.. عَرفت عنها أشاء كثيرة من أحاديثها،.. أحاول غالبا كبح فضولي المتحمّس اتجاهها، وأحيانا أحشده حول قصاصات من حياتها، ألصق بعضها على بعض لأجَمِّعَ لها وجهًا أضعه على الأحداث،.. مبدئيا لا أستنطق الناس عن ماضيهم، وأحاول إدارة فضولي بشكل مُهذَّب ليلتزم بالحدود، فلا آخذ من المتحدث إلا بقدر ما يجود، وصديقتي تُتقن الألعاب اللغوية ومن الصعب تَصَيُّدها، فهي مستمعة جيدة، ولا تدخل مع محدِّثها في سباق التعبير..
عملت مُرشدة اجتماعية لشرطة بلدها، وفيها التقت زميلها وتزوجته، بعد أن تشاركا قيمة خالدة اسمها الحب، في هذا المنعطف من الحديث معها تسقط بيننا حواجز السنين لصالح بوح بين امرأتين، تتحدث عن فقيدها مبتسمة كأنها تراه، وكمْ تخيلتُ معها صورة ظِلِّية لانعكاس وصفها،.. تقول: « لقد أعطاه السّمت العسكري المصنوع بالتدريب شكلاً نبيلاً وأنيقاً، متناظرا مع تماثيل الأبطال الإغريق، المُعبِّرة عن أبعاد أجسامهم بجَمالٍ يغازل الكمال ،.. ولد زوجي لمهاجرَيْن إلى بلدي، أبٌ تونسي أسمر وأمٌّ بولونية شقراء، فكان نتاجا عجيبا، بشرة حنطية مُذهَّبة، وعيون بلون الموج المحتضن للعشب، تتداخل فيهما الزرقة والاخضرار،.. غادر ذات يوم باتجاه غزَّة في بعثة تحقيق، فاردته رصاصة طائشة لجندي إسرائيلي ».. ثم تشير إلى البنصر منها، فما يزال يحتضن دبلته.
شَكَّلت صدمة نهاية زوجها، بداية لحياتها مع الزّهد، أقامت وقتا بتونس، ثم حطَّت هنا، تسمت باسم مريم، ومزَّقت تذاكر العودة.. وقعت في حب بلدنا ونمَّت نحوه إحساس المواطنة والانتماء ولو من غير وثائق،.. رغم اتساع الهوة بين بلدها، بدل المنشأ وبلدنا بلد المقصد، وجدت الأخير أكثر تناسقا مع فطرتها الزاهدة، وحلمت فيه بوئام متصالح مع ذاتها.
كانت مريم معنًى للتواضع المتفق عليه، فقد تحرَّرت من رقِّ المادة، قايضته بسلام داخلي منتج لسعادتها، فأعطت أفضل ما عندها، وأخرجت أجمل ما فيها.
عملت كثيرا، وعلَّمت، تتقن أكثر من مهارة، وكاتبة لاذعة بعقل مدهش، لا تعرف الهمس،.. أنفقت دخْلها على المحتاجين هنا ، وتقاسمت معهم راتب تقاعدها، وقاسمتهم بؤسهم في اتحاد حميم، وكأن الأمر تستلزمه طبيعتها المبشِّرة بمذهب الانسانية... هنا أيضا تعهَّدت يتيما بالتربية فيما يشبه التَّبني، وعاشت معه شكلا نشطًا من أشكال الأمومة، أمومة حُرمت منها،..
قبل وفاتها قَصَّر بها الحال لحد التَّعثر في قيود البؤس بمقاييس أهلها، لكن ما استزلَّتها قساوة الظروف، وما رأيتُها قطُّ تسترذل لطلب معونة.. العكس، كانت توحي لي دومًا بأنها عالقة في حياة مطمئنة كريمة.
تحدثني بسخرية عن قمع بعض الأحاسيس الملحَّة، كالتمتع بقطعة جبن فاخر أو قطعة شوكولاتة، أو تشكيلة من الفواكه، كانت بديهيات في حياتها السالفة، فأصبحت من رغبات الترف في حياتها اللاحقة، جرَّبت تقاسم وجبة من فخذ ديك مطمورة تحت ركام جراب من المعجنات، لتقود نفسها إلى حالة اكتفاء روحي.
تَعرَّضت صديقتي لخيانات صغيرة، ممن أحسنت إليهم من خليقة واقعة في اللؤم والجشع،.. كانت تتحسَّر لحظة على حالات استغلال لها، ثم ما تلبث تستدرك قائلة: «الخيانة طبع بشري قديم، صاحَبَ ميلاد خطايا نسل آدم»،.. وفي كل حالة تتجاوز الإساءة والتحايل بقدر كبير من السكينة والتَّسامي.
منذ سنتين بدأ منحناها العكسي بالتدرج، دفعتها شيخوختها المتهيِّبة من كورونا إلى الوحدة والعُزلة، كنت أزورها، أو أطلبها لزيارتي لأمنحها فرصة تصريف أنَّاتها، فالمسنُّ بحاجة لريِّ المشاعر، ورغم ثقل السنين واستسلام الجسد، قلَّما يُشاب تعبيرها أو تفكيرها بتخليط الذاكرة.
كلما حاولتُ أن أشلّها بقناعاتي المتوجسة، أو أشرد بها نحو عقلانيتها الغربية،.. أو بمعنى أوضح، كُلَّما ذكَّرتُها بحسابات عمرها في وضع غُربتها هنا، وفي حاجتها لرعاية لصيقة، هي حق مُسَلَّمٌ به في بلدها المترف خدماتيًّا،.. تلوّحُ بيدها خلف رأسها وتزمُّ شفتيها باستهزاء،.. وما فتَّت تخوُّفاتي في عضدها.. أشاكسها مُمازحة: سأبحث لكِ عن عريس من سلك الممرّضين، لكن اكتبي على البروفيل أنك عازبة بدل متزوجة، فتجيب أنها أرادت بتلك الصفة حماية نفسها من تحرش الطفيليات الالكترونية، فأردُّ : حتَّى أنتِ!، أمْ هوَّ تجسيد لحالة "لُخاظتْ تصرطْ ما تقنطْ"،.. فتضحك كثيرا.
مَلكتِ المرأة روحًا قويَّة للتمسك بالحياة، وكأنَّ رغبتها المُصمِّمة على الموت في بلدنا، أعانتها على إدارة جيّدة لما تبقَّى من حياتها، فبدت سلسة اتجاه فكرة الرحيل، لا تمانع في ترك الحياة في أيِّ وقت، أو كأنها عاشت بما فيه الكفاية!..
أنظر إلى جثمانها، وأحاول ضبط جنوح التفكير، لكن من الصعب أن نتحكَّم في كل خُطوات أدمغتنا، اسمعُ جلبة في ذاكرتي، سأتبيَّن أنَّ مصدرها اندفاع موكبٍ من الصّور إلى رصيف ذكريات جمعتني مع هذا الجسد المسجَّى أمامي،.. لكن ما عساها تثير الآن غير أسئلة لا يَتَعيَّنُ طرحها،.. فَشرعتُ في صمتٍ في رثاء صوَّر التقطتْ وسط اللاَّهويَّة، فلا أعلم من يُعزَّى فيها، أو من تُرثى لديه، لقد صادقتها وهي على عتبة عقدها السابع وتمخر اتجاه الثامن (إحدَى عشرةَ سنةً).. كان فصلا قصيرًا من قصتها معي بحساب الزمن، عريضًا من قصَّتي معها بحساب الحكمة، فقد سَمت برصيدي منها إلى ارتفاع آخر.
انفصلت صديقتي عن كل معيق دنيوي، وكانت راضية بحيازة حفرة على هذه الأرض لجسدها، حتَّى ولو كانت قبرا بشاهد مجهول، لن يزار من البعد...
ذكَّرتني نسبة الفشل في الباكالوريا بمقولة لأبراهام لينكولن تزيِّن جدار صفحتها
«Si l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance.»
وكما يُقال، سنرحل جميعا ولن يبقى غيْرَ الأثر، رحمها الله، وعند الله وحده يُلتمس الثواب.
.......ا
مَثقلْ المطوِّلات في الحمَّانْ.. انگولها عنكم.
مودَّتي.